dimanche 15 décembre 2013
samedi 19 octobre 2013
1943 JANVIER. L'embuscade de Sidi Saad.
Le 12 janvier 1943, à 0 heure, la patrouille à pied du Lieutenant De NAUROIS quitte BOU-GOBRINE.
La
nuit est étoilée, mais sombre. Il y a là 21 hommes, les meilleurs de
tous les volontaires, armés de 4 fusils-mitrailleurs, de 4 mitraillettes
américaines, perçues quelques heures auparavant, de grenades et de
pétards.
Pendant
la traversée de la plaine, l’ennemi lance de nombreuses fusées. C’est
son habitude, mais n’aurions-nous pas été vendus ? Dieu, que les chiens
aboient, aujourd’hui quand nous entrons dans SIDI-SAAD, guidés par un
indigène qui assure cette dangereuse mission pour la troisième fois,
sous la menace de nos mousquetons.
Une
visite chez Madame BUCH (vieille Alsacienne) qui tient à SIDI-SAAD, un
commerce d’épicerie, où les soldats italiens d’en face, viennent souvent
pour se ravitailler; nous pouvons compter sur son concours.
Le Lieutenant
de NAUROIS, profitant de la nuit, met tout son monde en place ; le
groupe du Maréchal des logis BOUSQUET à la Station, le groupe de
SASSE vers la chapelle, et enfin l’Adjudant NAUDIN et quelques « durs »
dans le jardin de Madame BUCH. L’ensemble du dispositif forme un « V »,
dont l’ouverture est tournée vers l’ennemi et la pointe à l épicerie où
le Lieutenant de NAUROIS et les « durs » doivent cueillir les italiens
pendant leur ravitaillement.
Le Cavalier
AMINALLAH nous amène comme otages, les cinq plus riches propriétaires
du hameau. Il affirme qu’il leur a bien expliqué que si un indigène
quittait le village, ils seraient tous passés par les armes. La
« djellaba » et le « chèche » blanc de l’un d’eux conviennent
parfaitement bien au Lieutenant De NAUROIS qui s’en affuble.
Le
jour commence à poindre ; ainsi déguisé, il peut circuler et aller voir
ses postes sans attirer l’attention. Tout le monde est bien caché ; il
ne reste plus qu’à attendre la venue de ces »messieurs »
Vers
7 heures 30, deux indigènes, à cheval, quittent le village au galop et
montent vers les lignes ennemies : la trahison ? Les otages comprennent
et tremblent…
Et,
en effet, vers huit heures, de la région de la ferme
de SIDI-SAAD commence à apparaître un nombre considérable d’Italiens ;
nous en comptons 24. Ils descendent vers nous et voici qu’ils se
fractionnent en deux groupes et qu’il apparaît clairement qu’ils veulent
encercler SIDI-SAAD.
L’une
des patrouilles déborde largement la Chapelle et progresse sur la route
de SIDI-SAAD –GOBRINE. Aussi, le Lieutenant de NAUROIS est-il obligé de
déplacer le groupe SASSE et de le mettre dans une haie de cactus, face à
l’Ouest.
Maintenant
la patrouille est à bonne portée : une cinquantaine de mètres. Elle n’a
pas dû nous voir. Un tireur italien et son pourvoyeur mettent leur
fusil-mitrailleur en batterie. Il ne faut pas leur en laisser le temps «
vas-y et bien ».
DUVAUCHELLE et LOUBET,
par deux rafales, clouent au sol les deux imprudents, tandis que FLOUS,
NAUDIN et le Lieutenant de NAUROIS et quelques mousquetons arraisonnent
les autres membres de la patrouille. Les mitraillettes américaines font
merveille et il est facile de régler le tir sur de telles cibles,
tellement rapprochées.
Les
Italiens sont cloués au sol : Ils ne bougent plus et l’un deux hurle,
voilà une situation rétablie. Le Lieutenant De NAUROIS, du côté de la
Chapelle, vide un chargeur sur deux retardataires, tandis
que LEROY l’approvisionne en munitions. Ils ne bougent plus. Tout va
bien.
Cependant,
dès le début de l’opération, le Lieutenant De NAUROIS avait lancé le
signal convenu pour appeler les « side-taxis », Bengale et fusées
rouges. Ceux-ci arrivent à une vitesse record et nous aident à prendre
en sandwich la patrouille. Tel est encerclé qui croyait encercler.
Mais la fusillade commence vers la gare ; c’est la deuxième patrouille ennemie dont
quelques téméraires ont réussi à se faufiler le long des cactus, au
bord de la voie ferrée et qui arrivent à bonne
portée. CALMEJANE et MARQUIS, du haut du grenier de la gare, font des
« cartons ». Deux imprudents sont étendus. Les autres pris de panique,
s’enfuient en désordre, poursuivis par le feu des mitrailleuses de 7,5
de DAUMESNIL.
Cependant, NAUDIN est
fou de rage ; il prétend que notre artillerie tire trop court et que
ses coups maintenant, tombent en plein sur nous.
Le
Lieutenant De NAUROIS lui fait remarquer qu’il commet une légère erreur
et que, seulement maintenant, le tir des canons italiens commence à
être réglé (vraisemblablement du canon de « 60 ». les premiers obus sont
tombés en plein milieu de nos ennemis, mais maintenant, ils encadrent
la station fort correctement ; un « side » a été atteint, mais sans aucun dommage, ni pour lui, ni pour son conducteur.
Le Lieutenant
De NAUROIS parcourt le terrain avec NAUDIN et les « Durs ». Ils
capturent trois hommes que nous pensions morts et leurs prennent armes
et munitions. Mais AMINALLAH, pendant ce temps veille, court, et ramène
un quatrième prisonnier. C’est le sous officier chef de la patrouille
qui se faufilait derrière les « raimas » et AMINALLAH le capture juste au moment où il nous mettait en joue. Il parait que
FORTIER-QUENTIN au télémètre, à l’observatoire, à 7 kilomètres de nous,
hurlait : « Attention mon lieutenant, ce salopard va vous tirer
dessus » Un peu comme au cinéma du quartier, quand on passe un film du
Far West.
Nos
abandonnons sur le terrain 8 cadavres ennemis, sans compter les otages
que FASSEL a « administrés » dit-il, en même temps qu’il essayait au
mousqueton d’enlever le casque d’un Italien.
L’interrogatoire
des prisonniers à HADJED et AIOUN, auquel assistait le Lieutenant
de NAUROIS, révèlera que les Italiens ont bien été prévenus par les deux
cavaliers indigènes, mais ceux-ci ont commis une erreur dont nous
leur sommes, après coup reconnaissant : ils ont annoncé cinq ou six
français à SIDI-SAAD. S’ils avaient su la vérité, il est probable que
les Italiens nous auraient envoyé un bataillon. Pauvres otages…
L’après
midi, les Italiens viennent ramasser leurs morts, et ils les lancent,
sans aucun respect, sur un chariot. Le lendemain, deux déserteurs se
présentent à nous, rescapés de la veille, écœurés par le coup de massue
reçu. Ils nous signalent que nous avons eu le grand tord de laisser sur
le terrain, près de la Chapelle, le lieutenant, chef de la brillante
expédition, blessé par un pistolet mitrailleur. Des indigènes l’ont
recueilli et soigné. « Il est capable de guérir, disent-ils »
Ils n’ont pas tiré un seul coup de fusil. « Vous êtes remarquablement bien armés » nous annoncent-ils. Tout est relatif.
Evidemment,
il nous a été impossible de manœuvrer les culasses des mousquetons
récupérés, tant il y avait de la rouille, et les fusils
mitrailleurs BREDA nous ont refusé tout service quand nous les avons
essayés. Pauvres gens… Pauvres soldats…
L’affaire de SIDI-SAAD a porté ses fruits, nos adversaires resteront vraisemblablement terrés dans leurs trous.

Présent à cet évènement, mon père est cité à l'ordre de la brigade avec l'attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 et une étoile de bronze.
(Décision
du 15 janvier 1943. Extrait de l'ordre général N°14. Signé Colonel
TOUZET Du VIGIER Commandant le groupement) - ci-annexée sa Croix de
Guerre.

Sources : Le 2ème RCA
au combat 1942-1945 – ouvrage tiré en 1000 exemplaires en souvenir des
combats du régiment. – Imprimé le 11 novembre 1945 sur les presses de P
CHANOVE
Imprimeur à COURBEVOIE pour les éditions J BAZAINE 6 avenue de MADRID à NEUILLY SUR SEINE.
Narrateur inconnu
***********
Le dessin du départ de la patrouille pour l'embuscade est du brigadier chef Gaston RATABOUL
Première rédaction de cet article le 13 octobre 2012- Actualisation le 22 juillet 2013
lundi 12 août 2013
ثقافة السير للوراء
في ثقافة الصراع كل مصارع يحسب أن رأيه لا يحتمل إلا الصواب، ورأي غيره لا يحتمل إلا الخطأ
في
ثقافة الصراع.. نحيا وتموت الأمة.. لا يهم غير أنفسنا.. لا يهم سوى إثبات
أحقيتنا في تصدر المشهد وتحقيق ما نريد، أيًا كان هذا الذي نريد، وهي ثقافة
ممجوجة، تنمو في مناخ الجهل، وتطغى في بيئة الفرقة والتشرذم، وغياب الأسس
الإيمانية التي دعمها الإسلام
في ثقافة الصراع يتخبط الجميع في غرفة مظلمة، فلا نحصد إلا المواجع والسير للوراء.
أما
في ثقافة الحوار فالأرض خصبة للتسامح، لسماع الرأي الآخر، للتنازل عن فكرة
تبين بعد اختبارها أنها ليست الأصح، الأرض خصبة للتواضع والمحبة.. لتقديم
مصلحة المجموع على مصلحة الذات، وللعودة إلى صف المفكرين المراجعين أنفسهم،
وعدم التثبت بمقدمة الركب طالما لا نمتلك ما يؤهلنا لذلك
بثقافة الحوار تتقدم الأمة، لأن الصحيح هو ما يسود
علاء عبد الفتاح
إن المتأمّل
لواقعنا اليوم يرى بأن ثقافةً الصراع انتشرت في عالمنا العربي، وتزكّيها
بعض وسائل الإعلام كمن يشعل النار في الهشيم، كيف لا، وقد جعل منها مادةً
دسمةً له، فنشر تلك الثقافة، فعمت وطغت بشكل لم يسبق له مثيل، فبتنا نلحظ
الصراعات بين أبناء الشعب الواحد؛ صراع الأهداف، صراع الرؤى، صراع الغايات،
صراع المبادئ، صراع الأفكار والمعتقدات، صراع الطموحات، صراع الآمال، صراع
القيم، صراع الأحزاب، صراع الماديات، صراع المصالح، صراع القوى
المتعارضة... مع أن منتهى الغايات هو الوصول إلى رؤى مشتركة تجمع أبناء
الشعب الواحد والأمة الواحدة، تعمل على تقليص الصراع والفجوات، لتحقيق
الآمال والأحلام لأبناء الأمة في الرقي والازدهار والعيش الكريم

وفي عالم كثرت فيه
المشكلات والثورات والتحديات والانفعالات لدرجة أننا لا نعلم منتهاها ولا
ما تؤول اليه، ومتى تنتهي، وإلى خير أَم إلى شرٍّ تتجه, فإننا بحاجة إلى
حلول جذرية لا مؤقتة أو مصطنعة، بحاجة إلى حلول توسطية تعين على إعادة
الأمور إلى نصابها، وتدفع بدفة السفينة إلى الأمام لا إلى الخلف, لأننا إن
بقينا في عالم الصراع بين القوى المتخالفة فإننا سنبقى عالقين في وسط
البحر، خائفين الغرق، بانتظار الفرج غير المضمون وغير المنطقي! وربما تكون
الخسائر فادحة.. فما نحتاج إليه اليوم هو السعي نحو بر الأمان، وهذا يتطلب
بدايةَ الاقتناع بأهمية ذلك السعي وضرورته لنا، من أجل تسديد الخطى أملًا
في الوصول إلى ذلك الأمان والاستقرار والرقيّ المنشود الذي نرجوه ونتمناه،
والوصول إلى شاطئ الأمان والاستقرار ليس بالأمر السهل، ولكنه في المقابل
ليس بالمستحيل! بل إنه يحتاج إلى الإرادة والتصميم وتوحيد الرؤى لبلوغ
الهدف
وتأمّل معي أيها
القارئ، كيف خلق الله الإنسان كائنًا اجتماعيًا ميّزهُ عن سائر المخلوقات
بالعقل والحكمة والقدرة على الكلام والحوار والإقناع، وميّزه بقدرات
تفكيرية وإبداعية تعينه في واقع حياته على حل مشكلاته، والارتقاء بمستوى
حياته.. ولكن من ينظر إلى الواقع اليوم يتعجب من حال أمتنا العربية لماذا
لا توظِّف ما حباها الله من تلك الميزات وما وهبها من نهج قويم من أجل حل
مشكلاتها في هذا الواقع؟ لماذا تقتنع كل الاقتناع بأنه لا حلّ بأيديها، وأن
مصيرنا بأيْدٍ غربيّة؟ وبأن قدرات أبنائها على حل المشكلات ليست بتلك
المستويات! وأن عليها اقتباس أو استيراد الحلول الجاهزة لمشكلاتها! أو أن
لا حل لمشكلاتها بغير تلك القوى العظمى (كما تُحب أن يُطلق عليها)! وأنّ
علينا أن نبقى في ركب التبعية على الدوام أو أن نفنى! أو أن نقبل بثقافة
يرضى عنها الآخر الأجنبيّ!
الاقتناع أولًا بضرورة الحوار
إن الدول التي حققت
اليوم ما تريد ووصلت إلى تغييرٍ في أنظمتها الحاكمة، عليها أن تبدأ
بالخطوة التالية، (حيث التغيير يبدأ من أنفسنا ومن قناعاتنا، والحلول
لمشكلاتنا يبدأ من ذواتنا، ومن سمو مبادئنا وأهدافنا، ومن توفيق الله تعالى
لنا، وبالاستعانةِ بكتابنا وشريعتنا، وبعقولنا وأدمغة مفكرينا، ويبدأ من
روعة منطقنا وحلاوة كلامنا) فعليها أن تبدأ بالحوار بين أبنائها، الحوار
البنّاء لإصلاح ما عليها إصلاحه، والبدء من حيث وصلت، فنحن بحاجة إلى حوار
يعيد لنا الأمل بحياة سعيدةٍ هانئة، لسنا بحاجة إلى جدالٍ هدّام، ولا إلى
نقاشٍ عقيم يقودنا إلى صراع أكبر وإلى استمرار النزاع والخلاف! وقبل ذلك
كله نحن بحاجة إلى الاقتناع بحاجتنا إلى الجلوس والتحاور بين أطراف الصراع،
حوارًا مثمرًا يقود إلى نتائج، والاقتناع به كأسلوب مهم وأساسيّ لحل
المشكلات والاقتراب (قدر الإمكان) من النتائج المُرضية لجميع الفِرق
والأفكار المتناحرة فكريًا وعقديًا. فعلينا الاقتناع أولًا بأهمية الجلوس
على الطاولة المستديرة، وإلا فكيف سنمارس فكرة مازلنا لا نؤمن بأهميتها؟!
بل ونطرحها كحل ولكن البعض يرفض تطبيقها أو التفاعل معها، مفضّلًا مصالحه
الذاتية على مصالح وطنه وأمته؟
يا بني البشر؛
خلقنا الله تعالى لكي نعمر الأرض بالخير والصلاح، وميّزنا عن سائر
المخلوقات بالقدرة على التواصل اللفظي والاقتراب من الآخر، والقدرة على
الاستماع، والأخذ والعطاء، والتفاعل مع الآخر.. من أجل البناء والتعمير،
ومن أجل سعادتنا أولًا وأخيرًا، لا من أجل التباهي والتفاخر بتلك القدرات
على بعضنا البعض! ونحن في زمن ازدادت به الوسائل الإعلامية ووسائل الانفتاح
على الآخر وعلى الحقائق وغير الحقائق، فإن مواردنا المعلوماتية والثقافية
أصبحت كثيرة وباتت متعددة، موثوقة وغير موثوقة، ولذلك لم يعد من السهل
الوصول للنتائج التوافقية، ما لم نقتنع من داخلنا بأهمية تلك الخطوة
(التحاور) ونسعى لها بأنفسنا. وإننا نرى اليوم أن كل من لديه فكرة أو مبدأ
أو حزب ينتمي إليه فإنه يتمسك بمعتقداته تمسكًا شديدًا بدون تقبل للتغيير
أو التعديل أو التحاور أو التكيّف، وهذا من الخطأ الذي نقع به، فمن طبع
الإنسان المبدع أن يتقبل التغيير والتعديل والحوار، فلعله يصل إلى التحسين
الحوار ثقافة بنّاءة
ومهما بلغت
التحديات في أمتنا العربية والتي زادت في زماننا، إلا أن لكل مشكلة حلًا..
أما بالنسبة لثقافة الصراع التي سادت بين أبناء الأمّة الواحدة الطامحين
لواقع أفضل، فإنّ أفضل ما يمكن أن يُحجّمها ويقلل من شأنها، هو الثقافة
المقابلة، وهي ثقافة الحوار، فالحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمةً
ورقيًا ومكاسبَ، وعلى وسائل الإعلام تشجيع ثقافة الحوار البناء الفعال، لا
ثقافة النزاع والخلاف والخسائر
فالحوار هو عمل
الأنبياء مع أقوامهم، والعلماء مع ذواتهم، والمفكرين مع بعضهم، والقادة
الناجحين مع مرؤوسيهم، والمربين الحقيقيين مع أبنائهم، والمنتجين مع
بلدانهم.. وهو أساس لنجاح الأب مع ابنه، والزوج مع زوجته، والصديق مع
صديقه، وأبناء الأمة مع بعضهم البعض، فالأمة القوية العزيزة المتقدمة هي
التي تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائها لا ثقافة الصراع، لأن الحوار مؤشر
قوي على الديموقراطية، والتي هي أقصى ما تطمح إليه الشعوب، وكلما ابتعدت
الأمة عن فتح آفاق الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية والحضارية كالتسلط
والذل، وهيمنة فئة على فئة، والكذب والمخادعة والغش، والنهب لمقدرات الأمة،
والتراجع والتأخر عن باقي الأمم... وهذا ما عاشته شعوبنا العربية لعقود
طويلة. وبالمقابل؛ فإنّ فتح آفاق الحوار في الدول الراغبة في الاستقرار بعد
التحرر يعني فتح آفاق الأمل، وآفاق التطور والعدل والديموقراطية والحياة
الأفضل
وانظر على سبيل
المثال (لا الحصر) كيف أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم" فتح باب
الحوار مع صحابته حتى في أحلك الظروف، فعندما نزل المجاهدون مع رسول الله
في غزوة بدر وراء ماء بدر، فسأله أحد صحابته (الحباب بن المنذر): «يا رسول
الله أهو منزل أنزلكه الله تعالى، فليس لنا أن نتقدّم أو نتأخر عنه، أم هو
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم" في تواضع
عظيم وتقبّل لآراء الآخرين: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»، فأخبره الحباب
برأيه: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء
من القوم (قريش) فننزله ونغوّر ما وراءه، ثم نبني عليه حوضًا فنملأه ثم
نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون»، بمعنى أن علينا أن نكون أمام ماء بدر لا
وراءه، فنشرب ولا يشربون، فتقبّل رسول الله عليه الصلاة والسلام الرأي
وغيّر موقع الجيش كله، وكان أن فتح الله تعالى عليهم بالنصر. وإن كان رسول
الله وهو أعظم البشر تقبل الرأي الآخر فما بالنا نحن لا نتقبل غير آرائنا
الشخصية وكأنها منتهى القول والغاية
ونذكر أيضًا قصة
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب في المسلمين أيام
ولايته شؤونهم، فأراد أن يُحدد قيمة المهر للنساء بحيث لا يتجاوز مبلغًا
معينًا، فوقفت امرأة وعارضته أمام كل من حضر، وأخبرته أن هذا ليس من حقه
لأن الله تعالى قال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا}(النساء: 4)، فالله تعالى لم يُحدد المهر وكذلك لم يحدده رسول
الله " صلى الله عليه وسلم" ، ولم يمنعه، فكيف تحدده أنت ياعمر؟ فكان أن
قبل عمر برأي المرأة بتواضع منه وتسامح واعترف قائلًا: أصابت امرأة وأخطأ
عمر! فهكذا كان العظماء يتراجعون عن آرائهم حينما يرون رأيًا صوابًا
سديدًا
مبادئ أساسية للحوار الفعّال
ولكي لا يكون
حوارنا حوارًا فلسفيًا أو عاجيًا أو بيزنطيًا (محاولة التفوق على الخصم
بأية طريقة) أو مضيعة للوقت فإن المتحاور عليه أن يضع نصب عينيه الالتزام
ببعض مبادئ الحوار التي إن تم التقيد بها فإننا حتمًا سنصل لنتائج مشتركة
فاعلة مقبولة، ومن تلك المبادئ
المبدأ الأول: تقبل رأي الطرف الآخر
كثيرًا ما يتقابل
المتحاورون وفي ذهن كل منهم فكرة ذاتية دفينة بأعماقهم، مؤداها أن رأيه هو
فقط الصائب المقبول، والذي لا رجعة عنه، وأن رأي الطرف الآخر هو الخاطئ
المرفوض تمامًا، ولا يمكن قبوله ولا بأي حال من الأحوال! فلا يمكن أن نصل
لحوار بنّاء ما دمنا نأتي للحوار وقد بيّتنا النية بعدم تغيير أيٍ من
أفكارنا أو آرائنا.. فالحوار لا يمكن أن يحصل بين طرفين يدعي كل طرف أنه
على هدى، وأنّ الطرف الأخر في ضلال مبين! فمن الصعب أن يتحقق الحوار في ظل
هذا المنطق الأعوج المبني على قناعات فكرية شخصية وحزبية متصلبة، لا يمكن
التراجع عنها أو تعديلها، فهنا ستبقى الهُوّة بين أطراف الصراع عظيمة،
فالبعض خوفًا من الاقتناع بالرأي الآخر نجده يقفل أبواب التحاور أمام
الآخرين بشتى الطرق. ولكي يتحقق الحوار المنتِج المرغوب به، فلابد أن نأتي
بعقلية ذهنية تقول: «إن رأيي صوابٌ يحتملُ الخطأ، ورأي غيري خطأٌ يحتملُ
الصواب»، عقلية التغيير والانفتاح على رأي الآخر وتقبل له.. لأن في نهاية
المطاف؛ إن لم يتم الوصول لحلول توافقية عادلة لجميع الأطراف فإن الفجوة
ستزداد شيئًا فشيئًا بمرور الزمن، ويكون الخاسر الأكبر هو الوطن
المبدأ الثاني: تقديم الأدلة والحجج المقنعة
إن الحوار الجاد
والفعال هو الحوار الذي يستند على البراهين والحجج المقنعة، والذي يتخذ من
الحجج العقلية سبيلًا لمعرفة الحق، وإثبات الرأي، وإقناع الطرف الآخر؛ كما
نرى في منطق القرآن الكريم في الحوار (كما في حوار الأنبياء مع أقوامهم)
إنه استند على الأدلة والبراهين والحجج والحقائق، وهذا هو الحوار المثمر
والمنتج. أما الحوار القائم على الشكوك والتوهمات ورفع الصوت والمجادلات
الفارغة، بدون برهان مقنع فلن يكون إلا حوارًا فاشلًا، وجدالًا عقيمًا، لا
هدف له إلا إضاعة الوقت وإقناع الآخرين بأننا جلسنا للحوار، ولكننا لم نصل
إلى شيء! فعلينا بالعمق في الحوار لأن التفكير السطحي هو الذي يغيّب العقل
والنتائج، ويقطع الحوار
المبدأ الثالث: الرغبة الصادقة في التوصل إلى حلول
عندما نعلن أننا
نريد التحاور من أجل التوصل لفهم مشترك أو حل قضية عالقة، فإنه لابد أن
يكون لدينا الرغبة الصادقة في الوصول للنتائج والوصول إلى الحق والصواب
والتغيير لصالح الوطن، حتى لا يكون جلوسنا للحوار ضربًا من إضاعة الوقت أو
رفع العتب! فعلينا أن نعطي الآخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم، وأن نكون
موضوعيين في طرحنا وفي قبولنا للحقائق والآراء، ومن الحِكَم السديدة: «رأس
الأدب كُله الفهم والتفهم والإصغاء إلى المتكلم». ومن المهم أيضًا التفاؤل
بالتوصل للحلول وحل قضايا الخلاف العالقة، ومن المهم نبذ التعصب للآراء
والمذاهب والأفكار والأشخاص، فالتعصب ظاهرة قديمة تمثل انحرافًا مرضيًا،
ينشأ عن اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر الحق وحده. والمتعصب لا يريد التوصل
لغير رأيه والسير على هداه، منتصرًا لنفسه أو مذهبه، وهذا ما نشاهده كثيرًا
في حواراتنا
المبدأ الرابع: الالتزام بأخلاقيات الحوار
ومن أهم أخلاقيّات
الحوار، الاستماع وحسن الإصغاء للطرف الآخر، وعدم مقاطعته حتى يكمل فكرته،
والصدق في الطرح لا المخادعة، واللياقة واحترام الحوار واحترام الآخر، وعدم
رفع الصوت فوق الدرجة الطبيعية، {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لانْفَُّّوا مِنْ حَوْلِكَ}(آل عمران:159). ولكن ما نتابعه اليوم من حوارات
عربية تنقلها وسائل الإعلام يظهر كيف أن هذه الأخلاقيات كثيرًا ما تُنقض
عراها واحدةً تلوَ الأخرى، أثناء الحوار، فيبدأ المتحاوران يقاطع كل منهما
الآخر، ودون استماع أو مناقشة، ومع رفع الصوت شيئًا فشيئًا إلى أن ينتهي
الحوار بالشتائم أو الضرب أحيانا! وبشكل بعيد كل البعد عن مفهوم الحوار!
والملفت للنظر أننا لا نلحظ مثل تلك السلوكات في الحوارات بين الأجانب،
عندما تنقلها وسائل إعلامهم، فلماذا لم نتعوّد الرقي والسمو في حواراتنا؟!
إننا بحاجة للتدرب على أسلوب التحاور السليم والراقي منذ الصغر في البيت
والمدرسة والمجتمع ووسائل إعلامنا، من أجل استخدامه كاستراتيجية موصولة
للحلول والأفكار السديدة
وكثيرًا ما ورد
أسلوب الحوار في القرآن الكريم (كما في حوار سيدنا إبراهيم عليه الصلاة
والسلام مع قومه، وحواره مع أبيه، وحوار موسى عليه السلام مع فرعون، وحوار
موسى مع هارون عليهما السلام، وحوار يعقوب مع أبنائه، وموسى مع الرجل
الصالح، وحوار صالح عليه السلام مع قومه، وسيدنا محمد " صلى الله عليه
وسلم" مع كفار قريش...) حيث الحوار يتوافق مع النفس البشرية وطبيعة العقل
البشريّ المفكر، وقد حث الله تعالى على الحوار البناء لا المجادلة الفارغة،
فقد قال عز وجل: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن}(النحل: 125).
وقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن
ترك المِراء وإن كان محقًا» (المِراء: الجِدال)(رواه أبوداود بسند حسن).
وقال عليه الصلاة والسلام: «فما ضلَّ قومٌ بعد هدىً كانوا عليه إلا أوتوا
الجدل»(رواه الترمذي وصححه
د. آندي حجــازي- أستاذة جامعية أردنية
jeudi 4 juillet 2013
La Politesse, quelle en est l'utilité ?
L’homme civilisé apprend à contrôler ses instincts primitifs et se distinct de l’animal qui réagit par pur instinct. La politesse est une attitude propre à l’homme et se définit par des codes de conduite.
La courtoisie fut certainement un pas important dans le processus de civilisation et à l’origine de la politesse. La courtoisie apparaît au Moyen Age, au moment où les gens « de la cour » désirent se distinguer de ceux du village. La vie sociale à l’intérieur de la cour, où cohabitent chevaliers, dames de la cour etc., s’organise alors autour des valeurs de la noblesse (grandeur des qualités morales et humaines, dignité, distinction…) qui se traduisent par le langage et le comportement « courtois ».

Les expressions « Noblesse oblige » ou « Noblesse d’âme » ou « d’esprit », signifient le désir d’agir par honneur, plutôt que par intérêt.
Plus tard « les bonnes manières » et la politesse sont devenues les signes d’une bonne éducation et également de l’appartenance à une classe sociale élevée, la haute bourgeoisie.
Aujourd’hui la politesse est devenue une valeur généralisée.
Selon les valeurs démocratiques, on est tous égaux et on doit respecter l’autre tel qu’il est. Le respect et la reconnaissance de l’autre se manifestent entre autre par le biais des rapports de politesse qu’on entretient.
Dans une société civilisée, basée sur le respect et sur des valeurs morales, on ne peut vivre ni selon « la loi du plus fort », ni selon « le chacun pour soi ». Pour éviter le chaos, la violence etc., la vie en communauté suppose que chacun respecte certains codes et règles, dont la politesse. Cette dernière facilite et rend le quotidien plus agréable. Elle définit une forme de communication et de comportement à adopter.
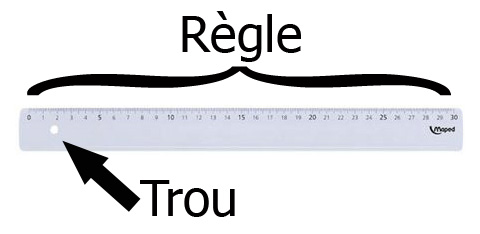
Les usages de la politesse se sont formés le long des siècles et ne cessent d’évoluer. Ils sont différents selon les époques et les cultures.
La politesse est une forme de communication fixe établie selon les moeurs et les circonstances. Les formules de politesse « standard » sont à la base de toute relation respectueuse et harmonieuse et définissent notre rapport au monde. Elles deviennent des habitudes, des moeurs à respecter. Elles rapprochent les personnes parce qu’elles établissent une première forme de communication. Ce sont des signes de reconnaissance, de respect et de sympathie envers l’autre.
Finalement elles nous guident et nous aident à être à l’aise face à des situations quotidiennes, habituelles ou non. La politesse est une force. C’est une forme de communication qui établit dès le départ un climat positif et qui évite à régler des problèmes dans la dispute, voire dans l’insulte. En général, les autres nous renvoient l’attention et le respect qu’on leur a donné.
Même si l’on apprend dès l’âge de l’enfance les formes de politesse, c’est avec le temps qu’on apprend à les appliquer de mieux en mieux. En devenant adulte, on sera de plus en plus à l’aise dans leur usage.
lundi 1 juillet 2013
العبارات المهذبة.. هل اختفت من تعاملاتنا اليومية؟
من فضلك.. آسف.. عفوا.. شكرا
حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على
التحلي بمكارم الأخلاق، فقال: (اتق الله حيثما كنتَ، وأتبع السيئةَ الحسنةَ
تَمْحُها، وخالقِ الناسَ بخُلُق حَسَن) [الترمذي
وجعل الله -سبحانه- الأخلاق الفاضلة سببًا للوصول إلى درجات الجنة العالية، يقول الله -تعالى-: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 133-134
وجعل الله -سبحانه- الأخلاق الفاضلة سببًا للوصول إلى درجات الجنة العالية، يقول الله -تعالى-: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 133-134
محمد حنفي
لا يختلف اثنان على أن لغة الحوار اليومية بين الناس في البيت والشارع والعمل وحتى في المدرسة والجامعة انحدرت، أصبحت جافة وعنيفة يسيطر عليها الصراخ ونظرات الاشمئزاز. اختفت، أو تكاد، تلك اللغة المهذبة التي تنم عن احترام الآخر، فمن يتحمل مسؤولية هذا الانحدار؟ التقينا مجموعة من المتخصصين للحصول على الإجابة
في البداية يؤكد المحامي عبدالله التركيت على أن العنف اللفظي أصبح يسيطر على لغة الحوار اليومية بين الناس، من البيت إلى الشارع، ومن أماكن العمل إلى المدرسة والجامعة. يقول
لا يختلف اثنان على أن لغة الحوار اليومية بين الناس في البيت والشارع والعمل وحتى في المدرسة والجامعة انحدرت، أصبحت جافة وعنيفة يسيطر عليها الصراخ ونظرات الاشمئزاز. اختفت، أو تكاد، تلك اللغة المهذبة التي تنم عن احترام الآخر، فمن يتحمل مسؤولية هذا الانحدار؟ التقينا مجموعة من المتخصصين للحصول على الإجابة
في البداية يؤكد المحامي عبدالله التركيت على أن العنف اللفظي أصبح يسيطر على لغة الحوار اليومية بين الناس، من البيت إلى الشارع، ومن أماكن العمل إلى المدرسة والجامعة. يقول
- لا ينكر أحد أن مساحة العنف تزايدت في المجتمعات العربية، ومن بينها الكويت، خاصة في السنوات الأخيرة، ومن يقرأ صفحات الحوادث يتأكد من ذلك. فنحن خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا وسمعنا عن جرائم عديدة هزت الرأي العام وتابعها كل بيت من فرط دمويتها، ويبدو أن جرعة العنف هذه طالت حتى لغة الحوار اليومية التي تحدث بين الناس في كل مكان وعلى المستويات كافة، فلم تعد لغة مخاطبة الآخرين مهذبة واستبدلت بها مفردات عنيفة
معارك سببها كلمة أو نظرة
ويشير التركيت إلى أن الكثير من المشاجرات التي تتحول إلى معارك وقضايا بطلها الأول كلمة أو نظرة
- للأسف لم تعد لغة التخاطب تنم عن احترام متبادل، وأدى انحدار اللغة اليومية بين الناس واختفاء العبارات التي تنم عن احترام الآخر وانقراض ثقافة الاعتذار السبب في اندلاع الكثير من الخلافات التي وصلت إلى قاعات المحاكم
من يصدق أن الكثير من القضايا تبدأ بنظرة تنم عن الاشمئزاز من شخص إلى آخر لا تعجبه وتكبر «السالفة» وتصبح قضية كبيرة، وهذا نشهده حتى بين الشباب صغار السن في الشوارع والأماكن العامة، أو من يصدق أن معركة تندلع في إشارة مرور بسبب كلمة قالها سائق لآخر؟
حتى بين الكثير من الأزواج أصبحت لغة التهديد والوعيد والشتائم تسود بدلا من الحب والرحمة والحوار. واعتقد أن هذه اللغة الهابطة للتعامل بين الأزواج هي السبب في زيادة قضايا الطلاق. فالكثير من الخلافات الزوجية التي انتهت بالطلاق كان يمكن أن تقتل في مهدها، لو أن أحد الزوجين قال كلمة مهذبة أو اعتذر الطرف المخطئ للآخر
ولا أبالغ عندما أقول انه لو كانت اللغة السائدة بين الناس هي اللغة المهذبة التي تنم عن الاحترام مثلما كانت سائدة قديما أيام أجدادنا وآبائنا حيث كان الناس يفهمون الأصول، لاختفت %90 من القضايا، بل أكاد أؤكد أن عمل مكاتب المحاماة والمحاكم كان سينحصر على القضايا التجارية والمالية. لكننا للأسف نعيش في عصر مغلف بالعنف في كل تعاملاتنا، ولا مكان لمفردات المدينة الفاضلة
بحبك يا حمار
أما الاستشاري النفسي والاجتماعي د. خضر البارون فيرصد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى انحدار لغة الحوار اليومية بين الناس واختفاء العبارات المهذبة:
- التطورات الهائلة التي حدثت في مجتمعاتنا، وعلى رأسها الفضائيات والإنترنت والهواتف المحمولة، أدخلت إلى تعاملاتنا اليومية لغة تشتمل على مفردات هابطة، والمؤسف أنها أصبحت السائدة وتوارت العبارات المهذبة، كأنه أصبح من العيب أن تخاطب الآخر بـ«حضرتك» أو تقول «من فضلك» أو تعتذر بقول «آسف» عندما تخطئ في حق الآخرين
بل أصبحت وسائل الإعلام تعتمد هذه اللغة الهابطة طوال اليوم وعلى مدار الساعة، تقتحم أذنيك أغنيات ورنات هاتف هابطة من نوعية «بحبك يا حمار»، بل تحتفي الكثير من الفضائيات العربية بهذه الأعمال المليئة بالإسفاف التي يتأثر بها الأطفال في غياب رقابة الأب والأم. وما يحدث أن أجيال جديدة تنشأ وقد تربت على سماع هذه المفردات الهابطة، وأصبحت تشكل قاموسها وتتحدث به في تعاملاتها اليومية
من يتحمل المسؤولية؟
ويحمل د. البارون الجميع مسؤولية هذه اللغة الهابطة في الحوار اليومي بين الناس فيقول
- أنا أحمل الجميع مسؤولية غياب اللغة الحضارية التي تعتمد على مكارم الأخلاق وتقوم على التخاطب بالعبارات المهذبة والمحترمة ولا استثني أحدا، بداية من البيت الذي فرط في دوره الرقابي وأصبح الأطفال يطلعون على أشياء خطيرة في الفضائيات وعبر الإنترنت في غياب الأب والأم، أو يسمعان منهما لغة غير مهذبة في بعض الأحيان.. ومرورا بالمدرسة التي انحدرت فيها لغة الحوار حتى بين المعلم والطالب، وانتهاء بالإعلام الذي يقدم النماذج السيئة التي تستخدم هذه اللغة الهابطة على الهواء مباشرة، فأصبحت الفضائيات تقدم قواميس مسيئة تبدأ بالسب والشتم وتنتهي بالضرب. حتى الأفلام الأجنبية التي تقدم في الكثير من الفضائيات تشتمل على شتائم، والمصيبة أن الفضائيات تترجمها حرفيا
نحن في حاجة إلى إعادة النظر لخلق قدوة حسنة فى بيوتنا ومدارسنا لأبنائنا، وعمل ميثاق شرف بحيث لا يطلع أبناؤنا في وسائل الإعلام إلا على المواد الجيدة التي تعلمهم الأخلاق والقيم المحترمة
لغة الحوار هابطة حتى على الإنترنت
يؤكد خليل عبدالله، أستاذ الحاسوب في جامعة الكويت، أن هذه اللغة الهابطة تنتشر على الإنترنت التي من المفروض أن الغالبية العظمى من مستخدميها من المتعلمين والمثقفين
- المؤسف أن الطفرة التكنولوجية التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة لم ينلنا منها في عالمنا العربي والكويت سوى الغث وتركنا السمين، واللغة الهابطة التي تستخدم الإساءة الى الآخرين وشتمهم والحط من قدرهم وعدم مخاطبتهم بشكل محترم أول مظاهر هذا الجانب
من يدخل مواقع الدردشة والمنتديات، وحتى المواقع الاجتماعية الشهيرة التي يرتادها المثقفون والمتعلمون مثل الفيسبوك وتويتر وحتى عبر رسائل الـ sms، سيهاله كم الألفاظ الهابطة التي يستخدمها الشباب العربى ومن بينهم شباب الكويت
للأسف أصبح الكثيرون يعيشون بشخصية مزدوجة، واحدة في الواقع وواحدة في العالم الافتراضي. يتصور البعض أن شخصيته مختفية عن الآخرين، ومن حقه أن يعمل ما يشاء ويهين الآخرين كما يشاء من دون أدنى مسؤولية، ومن دون وجود لأقل معايير الأدب والأخلاق
الأخطر أن هذه الوسائل التقنية الحديثة أصبحت لا تشكل خطرا على الأسرة أو النشء فقط، بل تشكل خطرا على أمن الدولة نفسها. فالكثير من المعارك الوهمية على الإنترنت تبدأ برأي جارح ويكون الرد بالشتائم والألفاظ النابية
ونادرا ما ترى حوارا راقيا ومهذبا عندما تطرح قضية ما في هذه المنتديات، بل ان الشباب أصبح لديهم قاموس يشتمل على مفردات أبعد ما تكون عن الذوق والاحترام. الأمر يحتاج إلى رقابة من الأسرة ومن الدولة، وتوعية باستخدام الحوار الراقي على الإنترنت بدلا من هذه المعارك المليئة بالشتائم والمفردات الهابطة
vendredi 28 juin 2013
أهميّة العِلم والعمل لخدمة الإنسانية
هناء ثابت - باحثة في الدراسات الإسلامية
ها نحن نضع بين يديك أيها القارئ الكريم اللآلئ النفيسة ونقدّم لك من جواهر العلوم والمعارف ما يهيئ لك بناء التربية الصحيحة في نفوس أولادك وأهلك ومجتمعك على أحسن وجه، من خلال ما سطَّره الإسلام من تعاليم لأجل توفير أحسن الرعاية الطيّبة لكلّ البشرية، وما يؤهّل لكلّ سالك الخروج من المآزق الحرجة والمسالك الضيّقة سالمًا مسلمًا
 فما
أنت فاعل؟ بعد أن هديت إلى الرشاد، وعلمت ما لم تكن تعْلَم، أنت مطالب بعد
أن اقتنيت هذه المجموعة الضخمة من الجواهر الثمينة، ببناء المستقبل
الأخلاقي الباسم، والإسلام يطالبك بدفع الثمن
فما
أنت فاعل؟ بعد أن هديت إلى الرشاد، وعلمت ما لم تكن تعْلَم، أنت مطالب بعد
أن اقتنيت هذه المجموعة الضخمة من الجواهر الثمينة، ببناء المستقبل
الأخلاقي الباسم، والإسلام يطالبك بدفع الثمن
أتدري ما ثمن هذه الحِكَم والمواعظ؟؟ الثمن هو التنفيذ والتطبيق.. الثمن هو العمل بعد العلم
فيا بناة المستقبل: ثمن العلم هو العمل،
وهو سلوك الطريق السوي بعد الاهتداء على ضوء مصابيح الهداية، هو السير في
مضمار العناية بالأخلاق وفق المناهج المخططة للسير المستقيم
العلم والعمل محورا السير وشريكان في قرن
لا يصلح أحدهما بدون الآخر، ومَثَلُ العلم كالمصباح المنير ومَثَلُ العمل
كالشّخص الفَذ البصير، فمتى استضاء البصير بالنور تركّزت لديه قواعد الحياة
وفق مناهج السير السوي ونالت الإنسانية رغبتها في سبيل مجد المستقبل
روي عن عمّار بن ياسر "رضي الله عنه"
قال: بعثني رسول الله " صلى الله عليه وسلم" إلى حي من قيس أعلّمُهم
شرائع الإسلام فإذا قوم كأنّهم الإبل الوحشية، طامحة أبصارهم، ليس لهم همّ
إلاّ شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله " صلى الله عليه وسلم" فقال:
«يا عمّار، ما عملت؟» فقصصت عليه قصّة القوم وأخبرته بما فيهم من السّهوة
فقال: «يا عمّار، ألا أُخبِرك بأعجب منهم؟
قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم».. فعمّار بن ياسر يعجب من إنسانية
ضيّقة لا تعرف في الحياة من هم لها أكثر من الشاة والبعير وانغماس في حدود
هذه المادّية الضيّقة.. الشاة أو البعير وتفتنها موارد هذه الثروة عن
متابعة الهدف الإنساني في العلم، ويأسف عمّار أسفه الشديد على هؤلاء، فإذا
برسول الإنسانية يأخذ أسفه هذا ويتناوله بالصّياغة الحكيمة ويقول له: «ألا
أُخبركَ بأعجب منهم؟ قومٌ علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم» أي: عرفوا ما
جهل أولئك ثم مازالوا يدورون في فلك التخلّف عن التنفيذ والتطبيق فكانوا
والجاهل سواء في طمس معالم الطّاقة الإنسانية عن انطلاقتها التحررية نحو
النجاح الموفّق المرتقب!! وليسوا سواء في المسؤولية.. مضيع على علم، وضائع
على جهل!! فالعلم من شأنه أن ينير شعلة الوجود الإنساني لابتكار أيسر السبل
نحو حياة أفضل
والعالم من شأنه أن يتّخذ الإجراءات
العملية لخدمة الإنسانية وفتح الأبواب التي أغلقها الجهل فإذا تعلّم
المتعلّم ثم تنكّر للعمل فيكون مضيعًا على عِلم وليست هذه الصفة شيمة الفكر
الوضّاء والعقل المتحرر
كان سيّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: «مثل الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الأعمى يحمل سراجًا ليستضيء به غيره
وقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «مثل الذي يُعَلّم الناس الخير وينسى نفسه مَثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها أو كالسّراج يضيء للناس ويحرق نفسه»، وقال " صلى الله عليه وسلم" : «إنّ أناسا من أهل الجنّة ينطلقون إلى أُناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فيقولون: إنّا كنّا نقول ولا نفعل
لذا حَرص السلف الصّالح عند العلم أن يكون
العمل قرينه ورفيقه وقالوا: غاية العلم العمل.. وإنّ العمل نتيجة لازمة
للعلم وإلاّ كان العلم عبثًا من العبث، وليًّا للعلم عن قصده من الصلاح
والإصلاح وخيانة ظاهرة للمجتمع يستحق عليها صاحبها المقت من الله ومن
الناس، والأحاديث الشريفة صوّرت عِظم المسؤولية غدًا لِمن هجروا العمل
ولبسوا زينة القول فقال " صلى الله عليه وسلم" : «كل علم وبال على صاحبه
إلاّ مَن عمل به»، وفيما رواه الإمام أحمد عن منصور قال: نبّئت أنّ بعض من
يلقى في النار يتأذّى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ ما
يكفينا ما نحن فيه من الشّر حتّى ابتلينا بك وبنتن ريحك، فيقول: كنت
عالِمًا فلم أنتفع بعلمي. 

وقال " صلى الله عليه وسلم" : «لا تزول
قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وعَدَّ النبي " صلى الله عليه
وسلم" من جملتها: علمه ماذا عمل فيه؟ أي ماذا عمل فيما علم
وعن الحسن قال، قال رسول الله " صلى الله
عليه وسلم" : «ما من عبد يخطب خطبة إلاّ الله عزّ وجلّ سائله عنها أظنّه
قال: ما أراد بها؟ وكان مالك بن دينار: إذا حدّث بهذا الحديث بكى طويلًا ثم
يقول: تحسبون أنّ عيني تقرّ بكلامي عليكم وأنا أعلم أنّ الله عزّ وجلّ
سائلي عنه يوم القيامة، ما أردت به؟
وفي الحديث الشريف «أنّ الرجل لا يكون مؤمنًا حتّى يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون لسانه مع قلبه سواء ولا يخالف قوله عمله و يأمن جاره بوائقه
وكان أبوالدرداء يقول: إنما أخشى من ربّي
يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك
ربِّ، فيقول: «ما عملت فيما علمت؟
ومتى أدركنا هذا الهدي النبوي علمنا كيف
أنّ السلف الصالح تباطأوا في الاستظهار إذ كان قصدهم الأجلّ هو استظهار
العمل لا لوك اللسان وتكرار الرواية.. روى الإمام مالك في الموطأ: أنّه
بلغه أنّ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة ثماني سنين
يتعلّمها.. وذكر عبدالله عن أبيه عمر قال تعلم أبي عمر البقرة في اثنتي
عشرة سنة فلمّا ختمها نحر جزورًا
وكفى بالقرآن معلّمًا ومطالبًا المؤمنين
بالعمل بما علموا إذ قال سبحانه: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن
تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} – (الصّف:2-3
وهزّ القرآن جانب العقل الإنساني لاستطلاع
النتائج المترتّبة على ترك العمل بعد العلم فقال سبحانه: {أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (البقرة: 44
وذكر الله سبحانه من شأن الدّاعي أنّ
خلايا وجوده وحقيقة نفسه تنطق بما يقوله لسانه فقال حكاية عن شعيب صلّى
الله عليه وسلّم إذ نصح قومه: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ
عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ
إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (هود: 88)، فطبّق ونفّذ شعيب ما
يقوله لهم من قبل أن يدعوهم إليه
قال قاضي القُضاة (أبويوسف): كنت أمشي مع
أبي حنيفة فقال رجل لآخر، هذا أبوحنيفة لا ينام الليل، فقال أبوحنيفة:
والله لا يتحدّث الناس عنّي بما لم أفعل.. فكان يحيي الليل صلاةً ودعاءً
وتضرّعًا، فأبوحنيفة العالِم العظيم، منار الفقه الحنفي، كان الفضل في
انتشار علْمِه وتفتّح روضه- عمله بما عَلِم وورعه أن يقول الناس عنه ما ليس
فيه، ومن أثر هذا الإلزام لنفسه أن تراءت له الحقائق ونفذ نور بصيرته
إليها فطبق شرق الأرض وغربها ذكره وسارت الركبان بأقواله، كان يرى أن من
الفقه العمل قبل القول.. فهذا سبب النجاح الباهر الذي كسبه في حياته من
الأصالة في الرأي والنباهة في الذّكر، فممّا جعله صاحب الرياسة في الفقه
إلزام نفسه بالتنفيذ العملي لِما كان تَعلّم أو يُعَلِّم، فالعالِم الذي
يغبط على علْمِه هو الذي يكون مخزونه الاحتياطي من العمل أكثر بكثير من
أقواله حتى تكون له في آفاق مجتمعه الأرصدة الضخّمة من ثمرات عِلْمِه يجني
هو أوّل ما يجني من بركتها كما يجني الناس من ثمراتها
وقد ضرب رسول الله " صلى الله عليه
وسلم" مثلًا للّذي تحلّى بآداب دين الله عِلْمًا وعملًا فأفاد واستفاد
وأينع زهره وترعرع روضه كما ضرب مثلًا للّذي هوى وغوى ولم يقبل هدي الله
ولم ينتفع بتعاليم السماء.. فقال " صلى الله عليه وسلم" : «مَثَل ما بعثني
الله به من الهدى والعلم كمَثَل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيّبة
قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع
الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنّما هي
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل مَنْ فقه في دين الله تعالى ونفعه
ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلَّمَ» (رواه البخاري ومسلم
ففرق عظيم بين أرض فيها من كلّ فاكهة
زوجان أي تحفظ الماء ليشرب منه الإنسان والحيوان وبين أرض انتزعت منها
الفائدة ولم يُبارك الله فيها فلا تنبت إلاّ العذاب والخراب وحرمان الإنسان
والحيوان من نفعها وفي جنباتها العذاب الأليم!
ومن هنا يتبيّن عظيم المسؤولية ومقدار
الدّقة في وضع البرامج العلمية ويظهر على مسرح الحياة عظيم المسؤولية على
من يلي الإشراف على هذه المناهج والبرامج فعليهم تلْقى مهمّة إيقاظ العزائم
لدى روّاد العلم أن يشتاقوا للعمل مع العِلْم وعليهم توجيه الأنظار
واختيار الأساليب المبتكَرة في حلقات الدراسة ليلبس الطالب لبوس النفع من
العِلْم ويفهم كيفية الوصول إلى ثمراته وحل معضلات الحياة على ضوء ما تحصل
لديه من معرفة وعِلم مثمر، والأمانة العلمية ستطالب النشء الصّاعد بتقديم
أحدث النتائج المترتّبة على عِلْمهم حتى لا تتخلّف الأمّة عن مسايرة ركب
الحضارة ولتكون في مصافّ الأمم الحيّة المنتجة التي تركّز العلم لديها على
قواعد العمل الراسخ المفضي إلى ازدهار مطرد.
فالعالِم السطحي الذي يبقى وراء بريق الأقوال وحشو الدّماغ بالنظريات الفارغة يشقى وتشقى به أمّته، وقد استعاذ " صلى الله عليه وسلم" بالله من عِلْمٍ لا ينفع وقال " صلى الله عليه وسلم" : «إنّ أشدّ النّاس عذابًا يوم القيامة عالِم لم ينْفَعه عِلْمه
وصلّى الله عليه وسلّم مُعَلّم الناس الخير ورسول الهدى والإنسانية القائل: «ما اكتسب مكتسِب مثل فضل عِلْمٍ يهدي صاحبه إلى هدى أو يردّه عن ردى وما استقام دينه حتى يستقيم عَمَله
وقال " صلى الله عليه وسلم" : «مَنْ عَمِلَ بما عَلِم أورَثه الله ما لم يعْلَم
المراجع
-إحياء علوم الدين: للغزالي
-الهداية في الفقه الحنفي وشرحها، للمرغيناني
-في سنن الله الكونية، محمد أحمد الغمراوي
-العلم يدعو للإيمان، تأليف، أ.كريسي موريسون، وتعريب/ محمود صالح الفلكي
-العلم والإيمان، محمد خشبة
- مناهج الأدلّة في عقائد الملّة، لابن رشد
-تراث الإسلام، لجمهرة من المستشرقين
-الإبداع في مضار الابتداع، الشيخ علي محفوظ
على رقعة تحتويها يدان ،
| |
تسير إلى الحرب تلك ا لبيا د ق ،
| |
فيالق تتلو فيالق ،
| |
بلا دافع تشتبك ،
| |
تكر ، تفر ، وتعدوا المنايا على عدوها المرتبك ،
| |
وتهوي القلاع، ويعلو صهيل الحصان ،
| |
ويسقط رأس الوزير المنافق ،
| |
وفي آخر الأمر ينهار عرش الملك ،
| |
وبين الأسى والضحك ،
| |
يموت الشجاع بذنب الجبان ،
| |
وتطوي يدا اللاعبين المكان ،
| |
أقول لجدي: "لماذا تموت ا لبيا د ق "؟
| |
يقول: "لينجو الملك" ،
| |
أقول: "لماذا إذن لا يموت الملك ،
| |
لحقن الدم ا لمنسفك" ؟
| |
يقول: "إذا مات في البدء، لا يلعب اللاعبان"
|
Inscription à :
Articles (Atom)


















